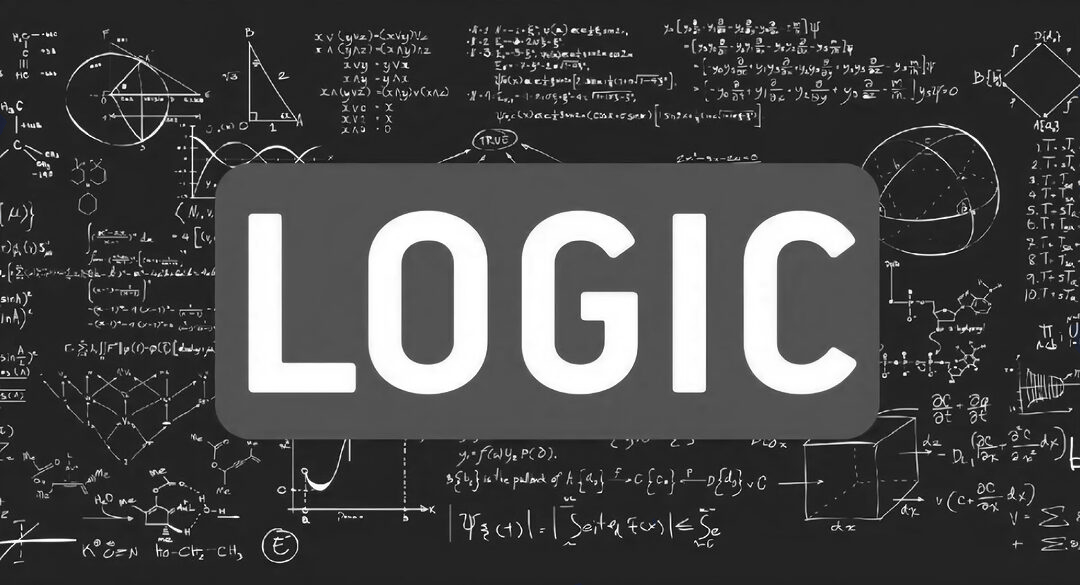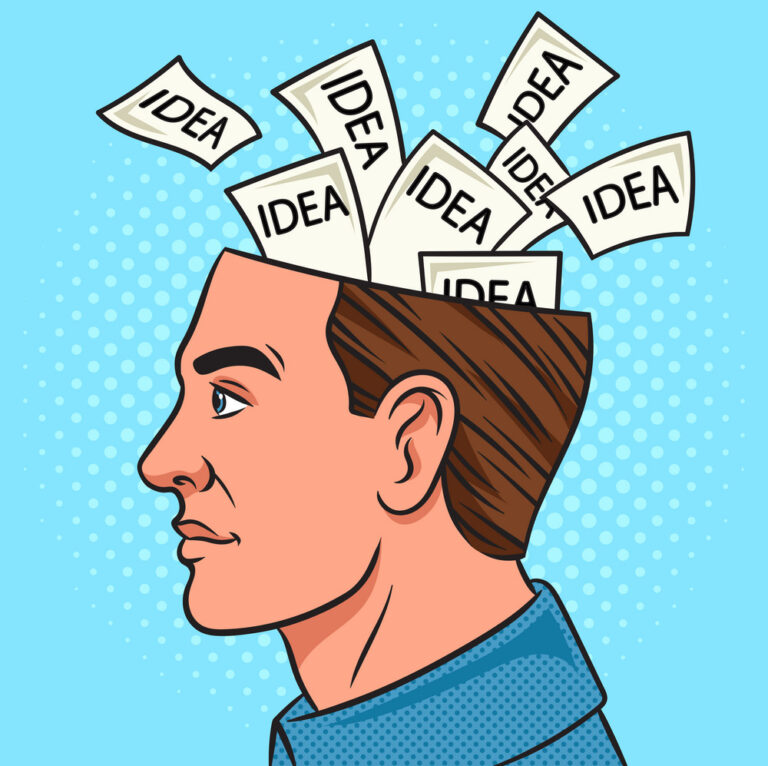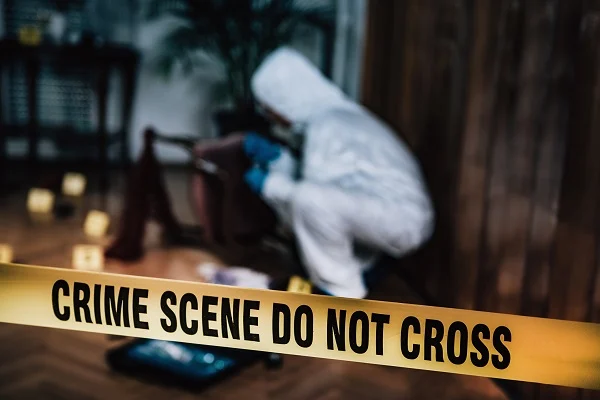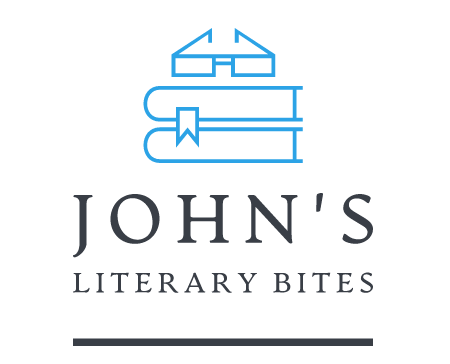مقدمة في المنطق (6) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: المغالطات المنطقية
- مقدمة في المنطق (1) مفاهيم المنطق الأساسية
- مقدمة في المنطق (2) التعرف على الحُجج والفرق بينها وبين التفسيرات
- مقدمة في المنطق (3) الحُجج الاستنباطية والحُجج الاستقرائية
- مقدمة في المنطق (4) المنطق واللغة – الإستدلال: (أ) تحليل الحجج
- مقدمة في المنطق (5) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: اللغة والتعريفات
- ☑ مقدمة في المنطق (6) المنطق واللغة – المنطق غير الصوري: المغالطات المنطقية
دا اخر مقال في الجزء الخاص بالمنطق واللغة، في المقالات اللي فاتت فهمنا ايه هو المنطق وايه هي الحُجج وبتتكون من ايه، وفهمنا أهمية وخطورة اللغة في صياغة الحُجج وفهمنا ازاي ممكن نحط تعريفات بشكل واضح قدر الإمكان للوصول لأرضية مُشتركة مع الطرف الآخر في الحوار أو الجدل. في المقال دا، واللي بيعتبر هو ذروة الجزء الخاص بالمنطق واللغة والمنطق غير الصوري، هنفهم ايه هي المُغالطات المنطقية وليه الأساليب دي في الإستدلال بتعتبر خطأ ومهم ان الواحد ياخد باله منها اثناء صياغته أو تقييمه أو نقده لأي حُجة.
خلونا نبدأ بتعريف بسيط للمُغالطة المنطقية:
المُغالطة المنطقية هي ببساطة عبارة عن حُجة قد تبدو صحيحة لكنها في الواقع بتحتوي على خطأ في الإستدلال.
في تصنيف المُغالطات المنطقية تم ملاحظة إن في بعض الاخطاء بتحصل بشكل متكرر بين ناس كتير، فهو النوعية دي من الأخطاء المتكررة اللي فيما بعد أصبح ليها تسميات واضحة.
المُغالطات المنطقية الحقيقة كتير جدًا وصعب أوي إنه يتم حصرهم في مقال واحد، لكن الحقيقة إن كل مجموعة مُغالطات بيتشابهوا في خواص مُعينة، ودا اللي هنناقشه بشكل مُختصر في المقال دا.
فاحنا في المقال دا هنناقش المجموعات (Categories) دي من المُغالطات المنطقية:-
- مُغالطات علائقية- Fallacies of relevance:
دي مجموعة مُغالطات بتكون فيها المُقدمات (premises) ملهاش علاقة منطقية بالإستنتاج (ممكن يكون ليها علاقة نفسية، وبالتالي تؤثر على إقناع المُستمع بالرغم من ان الحُجة مغلوطة). - مُغالطات الاستقراء المعيوب- Fallacies of defective induction:
دي مجموعة مُغالطات بتكون فيها المُقدمات ليها علاقة بالإستنتاج لكنها غير كافية للوصول ليه بشكل صحيح أو دقيق. - مُغالطات الافتراضات- Fallacies of presumptions:
دي مُجموعة مُغالطات بيتم فيها افتراض أشياء كثيرة في المُقدمات بشكل غير آمن أو بشكل يتطلب إثبات المقدمات في حد ذاتها. - مُغالطات الغموض- Fallacies of ambiguity:
دي مجموعة مُغالطات بتنشأ من غموض اللغة أو التعريفات أو استعمال مُصطلحات وعبارات لغوية بشكل غير مُتكافيء.
ممكن يبقى في مجموعات أُخرى من المُغالطات المنطقية، بس دول أشهرهم ودول اللي هنناقشهم دلوقتي.
أولًا- المُغالطات العلائقية- Fallacies of relevance:
مغالطة اللجوء للجماهير- The Appeal to the Populace fallacy (Argumentum ad Populum):
هي مُغالطة منطقية اللي بيحصل فيها إنه بيتم دعم وجهة نظر مُعينة أو استنتاج معين من خلال اللجوء لمعتقدات الجماهير. المغالطة دي هتلاقيها هي الأكثر إنتشارًا في خُطَب الحشد السياسي أو الديني في أي مكان في العالم. اللي بيخلي الناس تقع في المغالطة دي أو تقتنع بالطرح بتاعها لما الحجة تتقدم هو إن اللجوء لمُعتقدات الجماهير هو في الواقع لجوء لعاطفة الجماهير. المشكلة طبعًا في المُغالطة دي مش بس إنها غير منطقية، لكن إنها قادرة على الحشد من خلال استعمال اللغة بمصطلحات تقدر انها تستثير مشاعر المُستمع وبالتالي تحركه بدون ما يحصل نقد أو تمييز لمدى منطقية فعل مُعين أو سلوك مُعين.
أمثلية ليها مثلًا هو الآتي:
“معظم البشر عبر التاريخ آمنوا بوجود إله، إذًا وجود الله مؤكد.”
” أغلب الناس في مجتمعي بيؤمنوا بالدين دا، إذًا هو الدين الصحيح.”
” الغالبية في الاستطلاع أيدوا القرار دا، إذًا هو القرار الصحيح أخلاقيًا.”
مغالطة اللجوء للمشاعر- The Appeal to Emotion fallacy (Argumentum ad Misericordiam):
دي مغالطة منطقية بتتميز باللجوء للمشاعر، لكن مش لأي مشاعر، كلمة “Misericordiam” معناها “القلب الرحيم”. طبعًا الرحمة هو شعور نبيل جدًا، لكن اللجوء لشعور زي دا عوضًا عن المنطق هو اللي بيعتبر مغالطة منطقية وممكن يؤدي لكوارث. النوع دا من المغالطات أوقات بيحصل في المُحاكمات، على سبيل المثال في حالات كان فيها المُجرم تم بالفعل إثبات تورطه في قتل والده ووالدته واللي بيحصل ان المحامي بتاعه بيطلب الرحمة من القضاء على أساس إن موكله أصبح “يتيم”! المُغالطة دي منتشرة برضو في الشارع المصري للأسف لما بتحصل حالات تحرش مثلًا وفئة غير قليلة من الشعب تنادي بالرحمة للمجرم عشان منضيعش مستقبله، وطبعًا دا بيتم بالتوازي مع اللجوء للمغالطة السابقة عن طريق إستثارة مشاعر الجماهير الدينية بتعريفاتهم الدينية والطائفية عن “الحشمة” لمُحاولة التقليل من بشاعة الجريمة عن طريق لوم الضحية، لكن مش لومها على فعل غير قانوني بشكل منطقي، لكن بيتم لومها بناء على مخالفتها لمشاعر وأعراف الجماهير فيما بخص معتقداتهم الشخصية مش اكتر، فهو ببساطة المشاعر دي ملهاش علاقة ومبتنفيش إن الجُرم دا حصل.
مغالطة الرنجة الحمراء- The Red Herring fallacy:
دي مغالطة اللي بيحصل فيها إنه بيتم تشويش المستمع عن الموضوع الأصلي محل النقاش أو البحث أو الجدل، الاسم جه من إنه اوقات كان بيتم إلقاء رنجة حمراء للكلاب اللي بتحاول تصطاد تعالب عشان تشتتهم عن ريحة التعالب عن طريق الريحة القوية للرنجة. دي مغالطة برضو بيتم ارتكابها بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، على سبيل المثال لما نلاقي مثلًا في قرار بيتكلم عن إنه هيتم تشديد العقوبات المتعلقة بأذية حيوانات الشوارع فتلاقي حد يطلع ويقول “البشر أولى”، أو مثلًا زي لما بتشوف بلاوي معينة بتحصل في العالم والناس بتتعاطف مع ضحاياها فنلاقي ناس بتقول “طب وبالنسبة للناس اللي في غزة؟”، وفي حين إن طبعًا زي ما بيتم حماية الحيوانات لازم يتم حماية الإنسان وزي ما بيتم التعاطف مع ضحايا الحروب في العالم فشعب غزة مش استثناء من التعاطف دا بأي شكل من الأشكال لإنهم بشر زيهم وفي مجازر بتحصل ضدهم وفي حقهم، إلا إنه اللي بيحصل هنا إنه بيتم التشتيت عن الموضوع الأساسي، لإن كون إن البشر لازم يتم حمايتهم دا مينفيش إنه الحيوانات لازم يتم حمايتها (ملهاش علاقة) وبالتالي تشديد العقوبات هو تصرف صحيح ومتمش نقده على أسس سليمة، وكون إن شعب غزة بيعاني ولازم يتم التعاطف معاه دا مينفيش إنه لازم يتم التعاطف بنفس الكيفية مع ضحايا حرب أوكرانيا وروسيا أو ضحايا الحرب الأهلية في السودان أو ضحايا أي حروب في أي مكان في العالم (ملهاش علاقة).
مغالطة رجل القش- The Straw Man fallacy:
دي مغالطة بيتم فيها تشويه حُجة الطرف الآخر؛ إنك تهاجم رجل قش أسهل من إنك تهاجم رجل حقيقي من لحم ودم. اللي بيحصل فيها هو إن طرف من الأطراف مثلًا يكون بيحاجج لوجهة نظر مُعينة، فبدل إنتقادها بشكل واضح ومنطقي بيتم تضخيمها أو تحقيرها إلى حد يسهل نقده. يعني على سبيل المثال، إنك تلاقي حد بينتقد حركة زي حركة حماس وسلوكياتها الإجرامية فيتقاله إنت صهيوني وتبدأ تنتقد الحركة الصهوينية في حين إن هو أصلًا مش بيتبنى أطروحاتها ولا بيدعمها، أو العكس، إنك تلاقي حد بينتقد تعديات إسرائيل وسلوكياتها الإجرامية فيتقاله انت كدا بتدعم إرهاب حركة حماس وتبدأ تنتقد إرهاب حركة حماس على أساس إنك بتنتقده في حين إنه أصلًا مقالش إن الحركة دي بتمثله أو إنه بيتبنى أطروحاتها أو بيدعمها. المغالطة هنا إنك بتنتقد وجهة نظر متمش طرحها أو الدفاع عنها من أساسه، لكنك بتنتقد وجهة النظر دي لإن نقدها أسهل من فهم الطرف الآخر ونقد وجهة نظره بشكل صحيح.
مغالطة الشخصنة- Argument against the Person (Argumentum ad Hominem):
دي مغالطة منطقية بتحصل عن طريق إنك تستحضر أو تنعت الطرف الآخر بشيء شخصي عشان تدعم وجهة نظرك. يعني على سبيل المثال ممكن تبقى بتتناقش مع شخص عن نظرية التطور فبدل ما تستعمل المنهجية العلمية في تقييم الحجة تقوم ترفض الطرح لإنه ملحد أو إن شخص يقول إن نظرية الإنفجار العظيم صحيحة فانت ترفض طرحه عشان هو مؤمن أو متدين، أو مثلًا إن يكون حد بيقدم حجة مع أو ضد الإجهاض وانت ترفض طرحه عشان هو يساري أو يميني وبالتالي بتحاول من خلال النعت دا إنك تستنتج إن حجته أو طرحه خاطيء. تخيل مثلًا إن جالك شخص انت عارف إنه غبي وقالك إن الأرض كروية، مينفعش عشان هو غبي تستنتج إن اللي قاله غلط، لإنه من الممكن إن شخص غبي يقول إن الأرض كروية ببساطة لإنه نقل المعلومة من شخص أذكى منه. لاحظ إن مُغالطة الشخصنة مش هي إنك بتنعت الطرف الآخر بمعلومة خطأ بالضرورة (الشخص دا فعلًا ممكن يكون متدين أو ملحد أو يساري أو يميني أو أيًا كان)، المُغالطة مش هي النعت في حد ذاته، المُغالطة هي إنه النعت دا ملوش علاقة باستنتاجك. يعني لو جالك واحد غبي وقال حاجات غبية فانت استنتجت إنه غبي، هنا دي مش مغالطة منطقية دا استنتاج منطقي سليم (ممكن يكون تعبيرك عن الاستنتاج ذوقيًا مش أفضل حاجة، لكنه مش ضد المنطق). مُغالطة الشخصنة هي مُغالطة علائقية، مش المُغالطة إنك تقول لواحد إنه غبي، المُغالطة هي إنك تربط ما بين الصفة أو النعت دا وما بين وصولك لإستنتاج مُعين، المُغالطة هنا هي إن الاستنتاج بتاعك محتاج يتم إثباته أو نفيه بأُسس منطقية، نعت الطرف الآخر بشيء أو صفة (قد تكون فيه وقد تكون مش فيه) مش بيدعم ولا بينفي الاستنتاج بتاعك.
مُغالطة المُغالطة- The Fallacy fallacy:
دي مًغالطة منطقية بتتلخص في إنك تستنتج إن الطرف الآخر استنتاجه خاطيء لإن حُجته بتحتوي على مُغالطة منطقية.
الاسلوب دا في الاستنتاج يعتبر مُغالطة لإن المُغالطات المنطقية بتكشف عيوب في الوصول من مُقدمات الُحجة للإستنتاج بتاعها، لكنها مش بتقدر تقيم إذا كان الاستنتاج صحيح أم خطأ. تقييم صحة الاستنتاج أو خطأؤه لازم يتم بُحجة منطقية. واكتشاف إن في مُغالطة في حُجة الخصم مش سبب كافي إنك تستنتج إن استنتاجه خطأ.
يعني بص مثلًا على المثال التالي:
مُقدمة: كل الناس بتقول إن التدخين مضر بالصحة.
استنتاج: إذًا التدخين مُضر بالصحة.
هنا الحُجة فيها مُغالطة منطقية (وهي مُغالطة اللجوء للجمهور)، زي ما وضحنا، مش معنى إن الجمهور بيقول حاجة إنها صح، فهو هنا تم إرتكاب مُغالطة منقطية فعلًا، والحُجة دي حُجة منطقيًا سيئة.
مُغالطة المُغالطة بقى إنك تستنتج إن الحُجة السابقة الاستنتاج بتاعها خطأ لإن الحُجة فيها مُغالطة منطقية (بمعنى إنك تستنتج إن التدخير غير مُضر بالصحة، نظرًا لإن اللي قال الحُجة إرتكب مُغالطة منطقية).
فهي مُغالطة المُغالطة ممكن تُصاف بالشكل الآتي:
مُقدمة: حُجتك فيها مُغالطة منطقية (اللجوء للجمهور).
استنتاج: إذًا استنتاجك خاطيء.
الحقيقة، هي إن المُقدمة ملهاش علاقة بالاستنتاج، ممكن حد يبقى بيحاول يدلل على طرح صحيح أو حقيقي لكنه معندوش القدرة المنطقية أو المعرفية الكافية فبيرتكب مُغالطة منطقية اثناء الاستدلال، كونه هو إرتكب مُغالطة منطقية في الحُجة الخاصة بيه دا مش معناه إن الاستنتاج صحيح أو خطأ، صحة أو خطأ الاستنتاج لازم يتم بحجة منطقية أُخرى.
في مُغالطات منطقية تانية كتير ممكن تُضاف للمجموعة دي من المُغالطات العلائقية، لكن هنكتفي بدول دلوقتي.
ثانيًا- مُغالطات الاستقراء المعيوب- Fallacies of defective induction:
مغالطة اللجوء للجهل- The Argument from Ignorance (Argumentum ad Ignorantiam):
دي مغالطة بيتم فيها قبول صحة طرح مُعين لإنه متمش إثبات خطأ الطرح دا، أو العكس إنه بيتم قبول خطأ طرح مُعين لإنه متمش إثبات صحته. المُغالطة هي لجوء للجهل لإنه اللي بيحصل إن اللي بيرتكب المُغالطة دي لما بيبقى “مش عارف” صحة أو خطأ طرح مُعين فهو بيستنتج إنه صحيح أو خطأ بناء على إن الطرف الآخر مش عارف يثبت خطأ أو صحة الطرح بتاعه. ببساطة في أطروحات كتير احنا منعرفش هي صح ولا غلط، التصرف المنطقي في الحالة دي هو الاعتراف بالجهل دا، لكن اللي بيحصل في المُغالطة هو إنه بيتم إستغلال الجهل دا للوصول لصحة أو خطأ طرح مُعين. يعني على سبيل المثال، احنا لحد انهاردة مفيش نظرية قوية بتفسر ازاي تم بناء الاهرامات، مينفعش بناء على إن مفيش نظرية قوية قادرة تفسر بناء الاهرامات إننا نروح نستنتج إن اللي بناها كائنات فضائية أو إن اللي بناها حضارة سابقة على الحضارة المصرية، دي كدا مُغالطة لجوء للجهل، الطرح بتاع إن اللي بناها فضائيين أو حضارة سابقة هو في حد ذاته طرح أو افتراض محتاج أدلة تدعمه اكتر من مجرد إن النظريات الحالية مش قادرة تفسر الظاهرة دي، وعشان كدا المغالطة دي بتعتبر مُغالطة استقراء معيوب، لإن كون ان مفيش نظرية قوية بتفسر الموضوع في الوقت الحالي دا مش سبب كافي لإثبات وجهة نظر أُخرى، الاستنتاج المنطقي الصحيح في الحالة دي هو إننا ببساطة لسة منعرفش الاهرامات اتبنت ازاي وبالتالي التصرف المطلوب هو المزيد من البحث.
المُغالطة دي برضو هتلاقيها بتستعمل في جدالات حوارات الأديان بشكل كبير جدًا، أشهرها مثلًا لما يبقى في جدل ما بين طرف ملحد وطرف مؤمن والطرف المؤمن يقول إن مفيش نظرية قوية بتفسر الحياة بدأت ازاي أو الكون جه ازاي وبالتالي بيستنتج إن في إله، دي برضو أحد أمثلة مغالطة اللجوء للجهل وفي فلسفة الدين بتتسمى بمغالطة (إله الفجوات- إله الفراغات- God of the gaps)، واللي بيحصل فيها إن الطرف اللي بيحاجج لوجود إله عادًة بيلجأ للفجوات اللي لسة العلوم الطبيعية مفسرتهاش ويحاول يُقحم فيها مفهوم الإله. لاحظ هنا إنك عادي إنك تكون مؤمن وبترفض الحجج اللي بالشكل دا لإنها مغلوطة، مش معنى إنك رافض الحجة اللي فيها مُغالطة منطقية إنك رافض الاستنتاج أو الطرح اللي هي بتحاول تثبته. المُغالطات المنطقية بشكل عام هي مُغالطات بتوضح إن الإستدلال خاطيء، مش إن الطرح او الإستنتاج هو اللي خاطيء.
مُغالطة اللجوء لسلطة غير معنية- The Appeal to Inappropriate Authority fallacy (Argumentum ad Verecundiam):
اللجوء لرأي السُلطات بشكل عام مش شيء مُستحب في الجدل المنطقي، لكن أحيانًا بيكون اللجوء ليها نافع ومُجدي إذا كانت السلطة دي معنية بالموضوع، على سبيل المثال، وقت ما ظهر وباء الكورونا كان الطبيعي إنه يتم اتخاذ اجراءات بناءًا على آراء المُجتمع العلمي والطبي، دي سلطات معنية بالأمر، ممكن منطقيًا ميكونش أفضل شيء إنك تنفذ آراؤهم منغير ما تفهمها كلها وتقبلها بشكل منطقي، لكن قبولها شيء عملي لإنها سُلطات معنية بالموضوع دا من الدراسة والتخصص، وفي حين إنها إحتمالية واردة إن كل المجتمعات الطبية حوالين العالم تكون خطأ فيما يخص الاحتزرازات الخاصة بالأوبئة، إلا إنه على الجانب الآخر تجنب آراؤهم وقبول آراء سُلطات أُخرى غير معنية بالموضوع هيكون مُغالطة تبعاتها اسوأ بكتير من اللجوء لرأي السُلطة المعنية.
المشكلة في إن البشر بشكل عام مش دايمًا بقى بيميزوا في الجزئية دي وأوقات بيلجأوا لسُلطات آُخرى حتى لو كانت غير معنية بالموضوع (غالبًا لأسباب نفسية)، يعني مثلًا في أمريكا في مؤسسة معروفة باسم مؤسسة ديسكفري (Discovery Institute)، المؤسسة دي بتحاول تجمع دعم من العلماء لدعم وجهة نظر غير علمية معروفة باسم “التصميم الذكي- Intelligent design” بدل من دعم نظرية التطور اللي بيتم تدريسها في كل المدارس الحكومية الأمريكية وكل الجامعات حوالين العالم من أمريكا لليابان. اللي هتلاحظه مثلًا في القائمة اللي جمعوها من العلماء اللي بيأيدوهم هو إن بعض منهم حاصل على جايزة نوبل، لكن الحقيقة إنه الغالبية العُظمى من القائمة دي لعلماء تخصصاتهم ملهاش علاقة بالاحياء وحتى اللي حاصلين على جايزة نوبل حاصلين عليها في تخصصات غير الطب. فهنا تم اللجوء لسلطة (العلماء) لكنها سلطة غير معنية بالقضية محل الجدل (التطور وعلم الاحياء).
المغالطة هنا هي مغالطة استقراء معيوب لإن السلطات مغير المعنية غير كافية إنها تقول رأي informative أو ليه قيمة في القضايا محل الجدل أو المناقشة.
مُغالطة التعميم غير الدقيق- Hasty Generalization fallacy:
دي مغالطة منطقية بيتم فيها تعميم شيء أو طرح أو فكرة معينة على نطاق كبير وواسع بشكل غير دقيق. لاحظ هنا وخلي بالك إن المُغالطة هنا هي مُغالطة استقراء معيوب، المُغالطة مش في التعميم في حد ذاته لكن المُغالطة في إن التعميم بيتم بناء على مُقدمات (premises) غير كافية للوصول للإستنتاج أو الطرح. التعميمات في حد ذاتها مش مُغالطة منطقية، لكن التعميمات ليها أُسس علمية واحصائية لما مش بتتم بيها بيُصبح ساعتها التعميم دا غير دقيق. ودا هنتعرضله أكتر في الجزء التالت من السلسلة قدام لما نتكلم عن الاستقراء والعلم والاحتمالات.
في طبعًا مُغالطات أُخرى خاصة بالاستقراء المعيوب، لكن هنكتفي بدول دلوقتي.
ثالثًا- مُغالطات الافتراضات- Fallacies of presumptions:
مُغالطة السؤال المُركب- Complex Question (Plurium Interrogationum):
دي مُغالطة اللي بيحصل فيها هو افتراض اجابة او استنتاج مُعين داخل السؤال، في حين إن الاجابة دي او الاستنتاج دا مش مُتفق عليه من الطرفين أصلًا. زي مثلًا إني اسألك “من هو ملك مصر الحالي؟”، أي اجابة على السؤال دا هتكون غلط لإن مصر مش نظام ملكي من الأساس.
واحد من أشهر الأمثلة للمُغالطة دي مثلًا هو السؤال بتاع “من خلق الله؟”، واللي بيفترض فيه الطرف المُلحد إن الله لازم يكون ليه خالق في حين إن دا افتراض مش مُتفق عليه بينه وبين الطرف المؤمن.
مثال آخر هو السؤال بتاع “من خلق الكون؟” وبيحتوي على مُغالطة من الطرف المؤمن لما بيحاجج الطرف المُلحد لإن الطرفين مش مُتفقين على إن الكون “مخلوق” أصلًا.
مُغالطة المُصادرة على المطلوب- Begging the Question (Petitio Principii):
في المغالطة دي اللي بيحصل هو إنه بيتم افتراض النتيجة أو الاستنتاج المُراد إثباته من المُقدمة نفسها بشكل تعسفي، مما بيجعل الحجج اللي بالشكل دا عبارة عن استدلال دائري (Circular reasoning). يعني بص مثلًا على الاقتباس دا:
” إن السماح لكل إنسان بحرية غير محدودة في الكلام يجب أن يكون، في المجمل، نافعًا للدولة؛ إذ إن من المفيد للغاية لمصالح المجتمع أن يتمتع كل فرد بحرية كاملة وغير مقيدة في التعبير عن آرائه.”
اللي حاصل هنا هو ان المُتكلم موضحش ليه حرية التعبير شيء صحي ونافع للدولة، لكنه افترض الرأي اللي عايز يقوله في المُقدمات بتاعته.
فهو بشكل عام مُغالطات الافتراضات كلها تعتبر مُغالطات استدلال دائري بشكل أو بآخر، بمعنى إنها بتلف حوالين نفسها، يعني إنه بيقول إن مثلًا أ بيثبت ب، ب بيثبت ج، ج بيثبت د، د بيثبت أ. فهو اللي بيحصل إنه بيعمل دايرة استدلال مغلقة بشكل أو بآخر، أحيانًا زي ما بيحصل في مُغالطة الاستدلال المُركب اللي بتفترض النتيجة اللي انت عايز توصلها في السؤال اللي بتسأله لخصمك وانتو أصلًا في الأساس مش متفقين إن الافتراض اللي في السؤال صحيح، أو زي ما بيحصل في مُغالطة المُصادرة على المطلوب بإنك بتصيغ المُقدمات بتاعتك بحيث تشمل النتيجة اللي انت عايز تثبتها.
هنا المُقدمات ليها علاقة بالنتيجة مش زي المُغالطات العلائقية، والمُقدمات إن صحت فهي كافية إنها تثبت الاستنتاج مش زي مُغالطات الاستقراء المعيوب، لكن الفكرة هنا إن المُقدمات في حد ذاتها مش متفق عليها مع الطرف الآخر لإن النتيجة مُفترضة مُسبقًا فيها.
هنكتفي لحد هنا فيما يخص مجموعة مُغالطات الافتراضات.
رابعًا- مُغالطات الغموض- Fallacies of ambiguity:
مُغالطة الإلتباس اللفظي- Fallacy of Equivocation:
معظم ألفاظ اللغة ليها اكتر من معنى، لكننا عادًة بنقدر نحدد أنهي معنى اللي بيتم استعماله للألفاظ من خلال السياق. مُغالطة الإلتباس اللفظي بتحصل لما يتم استعمال كلمة معينة في أحد مُقدمات الحجة بمعنى مُختلف عن المعنى اللي في مُقدمة أُخرى أو الاستنتاج. يعني بص مثلًا على المثال دا:
P1: Man is the only rational being in the living world.
P2: A woman is not a man.
C: Therefore women aren’t rational.
هنا في المُقدمة الاولى (P1) تم استعمال كلمة “Man” بمعنى الإنسان بشكل عام، بينما في المقدمة التانية (P2) تم استعمالها بمعنى الذكر، وبالتالي قاد للاستنتاج المغلوط (C).
لاحظ برضو أن أوقات كتير الألفاظ بيكون معناها نسبي (يعني بيكون ليها معنى فقط بمُقارنتها بشيء آخر)، على سبيل المثال، لو أنا قلت “أيمن شخص طويل” و”برج القاهرة مبنى طويل”، هنا كلمة “طويل” بتعبر عن نوعين مختلفين تمامًا من الطول، أيمن طويل بالنسبة لباقي البشر وبرج القاهرة طويل بالنسبة لباقي المباني، لكن الموضوع هيكون عبثي جدًا لو استنتجت من الجملتين دول أن أيمن وبرج القاهرة طولهم قريب من بعض بأي شكل من الأشكال.
فانت مثلًا ممكن تقول إن “الفيل عبارة عن حيوان”، و”الفيل لونه رمادي”، إذًا “الفيل حيوان رمادي”. الاستنتاج هنا صح لإن كلمة “رمادي” مش لفظ معناه نسبي. لكن هيكون غلط لو قلت مثلًا إن “الفيل عبارة عن حيوان”، و”الفيل الصغير عبارة عن حيوان صغير”، هنا الاستنتاج دا غلط، لإن “صغير” مُصطلح نسبي، الفيل الصغير يظل حيوان ضخم مُقارنًة بباقي المملكة الحيوانية.
لحد هنا دي أمثلة بسيطة جدًا على مُغالطة الإلتباس، بس جرب مثلًا تشوف حُجة زي دي، ودي واحدة من أشهر حُجج التصميم الدقيق (Fine tuning) على سبيل المثال:
مُقدمة 1: الثوابت الكونية مُصممة بشكل دقيق جدًا لدرجة إن أي تغير بسيط فيها هينتج عنه إنهيار الكون، كتلة النيوترينو على سبيل المثال هي 2×10^(-37) كجم.
مُقدمة 2: لو الكتلة دي اتغيرت أي تغير بسيط وقلت مثلًا لـ 2×10^(-38) كجم فالجاذبية هتكون ضعيفة جدًا ومفيش مادة هتتكون لكن كل المادة هتفضل تبعد عن بعد لحد ما الكون مكوناته تتفتت، أو لو زادت لـ 2×10^(-36) كجم فالجاذبية هتكون قوية جدًا والكون كله هينهار على بعضه.
استنتاج: أي تغيُر بسيط في الثوابت الكونية هيخلي الكون ينهار والحياة مستحيلة.
للوهلة الأولى، الحُجة قد تكون مُغرية جدًا، لكنها قايمة على إلتباس لغوي خاص بكلمة “تغير بسيط” وعلى وحدة القياس المُستعملة لوصف كتلة النيوترينو (اللي هو الكيلوجرام).
عشان تُدرك الخطأ اللي في الحُجة، خلينا نحاول نطبقها في حالة مختلفة. خلينا نفترض إني عايز أثبتلك إن طول الإنسان لازم يكون 170 سم، ولا اكتر ولا أقل.
لاحظ إن 170 سم يعني 1.8×10^(-16) سنة ضوئية.
دلوقتي خلينا نبدأ الحُجة:
مُقدمة 1: طول الإنسان مُصمم بشكل بالغ الدقة، فهو طوله 1.8×10^(-16) سنة ضوئية.
مُقدمة 2: لو الطول دا اتغير بنسبة قليلة جدًا وبقى مثلًا 1.8×10^(-17) سنة ضوئية الإنسان هيبقى طوله أصغر من ازازة المية وهيكون حجمه غير كافي إن يتحمل حجم مُخ بهذا التعقيد.
أو لو زادت وبقى مثلًا 1.8×10^(-15) سنة ضوئية فالإنسان طوله هيكون مُبالغ فيه جدًا وتصميم الجسم والعضم مش هيقدر إنه يدعمه.
استنتاج: الإنسان طوله لازم يكون 1.8×10^(-16) سنة ضوئية بظبط، ولا أكتر ولا أقل.
طبعًا انت ممكن تكون بدأت تلاحظ إن الحُجة دي هتبقى حُجة عبثية جدًا بمجرد ما بدأنا نتكلم عن طول الإنسان بالسنين الضوئية! ودا حقك طبعًا، لإن وحدات القياس اللي احنا بنستعملها احنا بنستعملها بشكل نسبي وبناء على عملية إستعمالها. فاللي حاصل في الحجة اللي انا صيغتها دلوقتي دي، هو إن التغير اللي حصل في الواقع مكانش تغير بسيط (هو كان ممكن يبقى تغير بسيط لو احنا بنتكلم مثلًا عن مسافات فلكية ونجوم بتبعد عننا ملايين السنين الضوئية)، لكنه تغير ضخم جدًا، نظرًا لإننا بنستعمل وحدة قياس مش من العملي إننا نستعملها في الكلام عن طول الإنسان.
في الحُجة الأولى الخاصة بالتصميم الدقيق، فالنيوترينو جُسيم صغير جدًا واستعمال وحدة قياس زي الكيلوجرام بالنسبة لكتلة النيوترينو عامل زي استعمال وحدة قياس السنة الضوئية بالنسبة لطول الإنسان، لكن لو هستعمل وحدات القياس المناسبة لكتلة النيوترينو (زي الـeV) ففي الواقع الحجة مش هتشتغل وهيبقى التغير البسيط ممكن يحصل عادي زي ما ممكن إنسان يكون طوله 160 أو 190 سم. فهو في الحجة دي تم استعمال كلمة “تغير بسيط” بمعنى مُعين في المُقدمة الأولى، ومعنى آخر في المُقدمة التانية. في المُقدمة الأولى تم استعمالها بمعنى أي تغير على الإطلاق، بينما في المُقدمة التانية تم استعمالها بمعنى تغير نسبي (نسبًة لوحدة القياس المُستعملة)، عشان يكون التغير النسبي دا غير مقبول، وبعد كدا في الحجة بيستنتج الاستنتاج بتاعه باستعمال نفس المعنى اللي في المُقدمة الأولى.
مُغالطة التركيب- Fallacy of composition:
دي مُغالطة بيتم فيها تعميم صفات مُكونات الشيء للشيء نفسه. يعني زي مثلًا الحُجة دي:
مُقدمة 1: كل لاعب في الفريق الفلاني مُحترف جدًا وممتاز.
استنتاج: الفريق دا فريق ممتاز.
الحقيقة من شرط، لإن في حين إن ممكن اللعيبة يكونوا مُحترفين جدًا كل واحد لوحده، لكن التعاون بينهم مش أحسن حاجة وبالتالي الفريق نفسه مش شرط يكون كويس.
مُغالطة التقسيم- Fallacy of Divison:
دي عكس مُغالطة التركيب، ودي اللي بيتم فيها إنه بيتم تخصيص الصفات الخاصة بالشيء لأجزائه، زي مثلًا:
مُقدمة 1: الفريق دا ممتاز.
استنتاج: كل لاعب في الفريق ممتاز.
الحقيقة طبعًا إنه برضه مش شرط لإن ممكن يكون الفريق كويس بسبب المُدرب والخطط اللي بتتعمل والتعاون بين أعضاء الفريق، لكن كل فرد لوحده مش شرط يكون على أعلى مستوى.
هنكتفي لحد هنا فيما يخص مجموعة مُغالطات الغموض.
الحقيقة إنه فيه مُغالطات منطقية كتير جدًا. ومش مطلوب من أي حد إنه يبقى مُدركهم كلهم أو عارف اسمائهم أو ما شابه، لكن مهم هنا إنك تبقى بتعرف تميز المُغالطة لما تشوفها (حتى لو مش عارف اسمها)، ودا بيحصل عادًة بتمرين كتير وتعود على إنك دايمًا تحلل وتنتقد كل شيء بتسمعه بلا استثناء، وإنك تحاول دايمًا تطبق نفس القوانين اللي بتطبقها على نفسك في الإستدلال على الطرف الآخر، ونفس النقد اللي بتوجهه للطرف الآخر في الحُجج بتاعته توجهه لنفسك وتطبقه على الحُجج بتاعتك. مُهم إنك تعرف دايمًا تدي أمثلة باستخدام نفس منهجية الحُجة بتاعتك وتشوف، هل الحُجة اللي بالشكل دا فعلًا قوية ولا ضعيفة.
مفيش حد حافظ كل المغالطات المنطقية أو عارف اسمائها كلها، وحتى اللي عارفين مش شرط دايمًا يكونوا بيعرفوا يستعملوا المنطق بشكل صحيح أو يتجنبوا الوقوع في المُغالطات المنطقية. تجنُب الوقوع في المُغالطات المنطقية مش هتقدر تعمله إلا بإنك تنتقد أفكارك انت الشخصية قبل أي حد تاني، ولما تسمع أي حُجة تكون دايمًا بتنتقدها وتحاول تدور على المُغالطات اللي فيها باستمرار. دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر بيها تتجنب الوقوع في المُغالطات المنطقية. النقد عبارة عن ممارسة وتمرين مُستمر دايمًا وملوش نهاية، ممكن ميكونش دايمًا مُريح، لكنه دايمًا هيضمنلك سلامة المعلومات اللي بتدخل دماغك ودايمًا هيكون هو الطريقة الفعالة لتصحيحها في حال كنت مُخطيء. وبما إن عقل الإنسان هو أغلى ما يملكه، فأعتقد إنه يستحق إنك تنقي المعلومة اللي بتدخله على أعلى معايير مُمكنة.